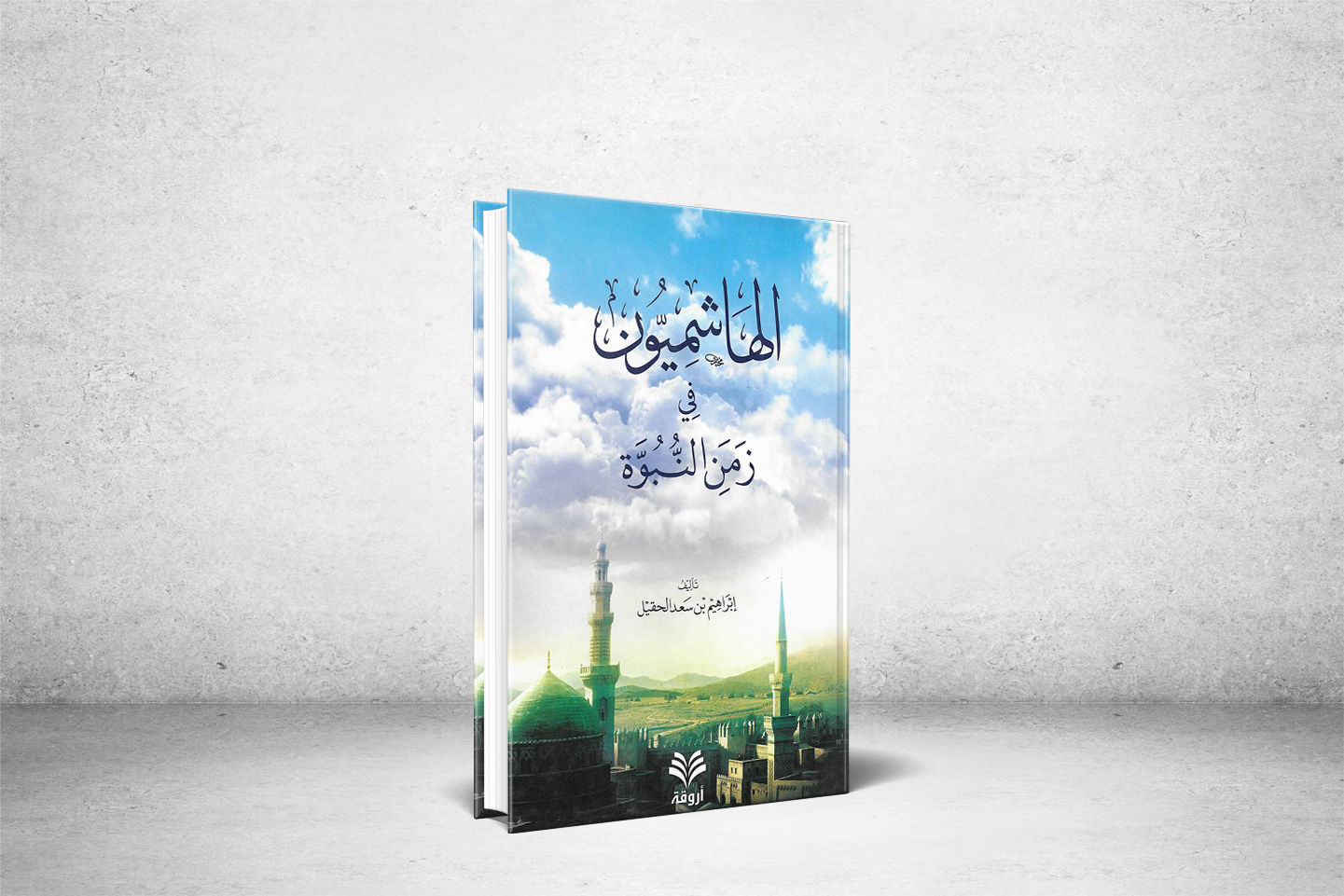
حوار: محمود عبدالله
إبراهيم الحقيل كاتب وباحث جلد يتميز بغزارة الإنتاج والغوص في كتب التراث واستخراج دررها المكنونة، أمد المكتبة السعودية والعربية بالعديد من الكتب والدراسات النقدية، وبكلمات قصيرة يفجر قضايا كبيرة، لديه الكثير من المشاريع البحثية التي يعمل عليها وعدد من المؤلفات منها: (وقفات نقدية مع من القائل لابن خميس، شعر الأخضر اللهبي (ت 105هـ) جمع ودراسة، قراءة نقدية لكتاب الأعلام للزركلي، شعر عبيد الله المسعودي (98هـ) جمع ودراسة، معجم مصنفات الزبير بن بكار، الهاشميون في زمن النبوة، أسرى بدر بين الهدى والضلال، وغيرها من الدراسات التي تنبش في تراثنا المجيد ليس نبش القبور وإنما نبش الباحث المدقق الذي ينفض الغبار ويستجلي النافع وينتقد ويزيح الضار... (أحوال المعرفة) أرادت أن تتوقف قليلا مع جهود الكاتب والباحث إبراهيم الحقيل وتقدم هذه المادة للقارئ العزيز من خلال هذا الحوار.
تعاني المكتبة العربية من ندرة كتب التاريخ الاجتماعي، فلماذا؟
انصب اهتمام العرب على الفرد، متناسين أن هذا الفرد هو نتاج المجتمع، فكثرت كتب التاريخ السياسي وكتب التراجم الفردية، وكلها تتناول تاريخ علية المجتمع، وبعض شرائح الطبقات الفاعلة في الذاكرة كالشعراء، فيما غفلت عن هذا المجتمع الذي يصنع هذه الطبقة المسيرة للمجتمع، على الرغم من وجود المجتمعات الكبيرة والمتنامية باطراد، مثل المجتمع البغدادي، وما فيه من إثنيات وأعراق ومذاهب وتكتلات مختلفة المشارب والأهداف، إن هذا التاريخ الذي بين أيدينا للقرون السابقة من العرب ال يطلعنا على نبض المجتمع وتطوراته التي ينبثق منها أحداث وفرق ونحل ومذاهب تتكتل وتوجد اسما لها في التاريخ ولكننا نحار في تفسير بداياتها وأسباب نشوئها، مثل تكتل المطوعة في بغداد نهاية القرن الثاني الهجري،. وقليلا ما يتناول المؤرخون العامة في كتبهم، حتى تلك الفرق التي نشأت كالخوارج والحشاشين والمطوعة وغيرهم يتم تناولهم من الزاوية السياسية، ومرد ذلك أن الكتابة قليلة وغير منتشرة، وصناعة الكتاب مكلفة ولا يستطيع العامة الوصول إليه لهذا كانت الكتابة لهم متوارية.
لكن هل يبدو أن الشعر كان اجتماعيا أكثر من التاريخ؟
نعم قد نجد إضاءات للتاريخ الاجتماعي في عالم الشعر، الذي يعد وثيقة شفوية. كما نجد قطعا من هذا التاريخ في نذر قليل من الكتابات ومثالها: كتاب البخلاء، ومثله كتاب الطفيلين للخطيب البغدادي، مثالا لا حصرا، وتشكل كتب الرحلات القديمة والحديثة رافدا للتأريخ الاجتماعي، التي قد يجد فيها الباحث والقارئ ذكرا للفئات الاجتماعية وطرق تعاملها وحياتها، من خلال نظرة الرحالة وليس من خلال الدرس الاجتماعي. والفتاوى التي ظهرت في القرون المتأخرة لكنها قد تكون مبتسرة وانتقائية وتخلو من التفصيل في الجواب ألن القصد الجواب وليس السؤال.
هل فطن المؤرخون الحاليون لغياب التاريخ الاجتماعي؟
حتى الآن نعاني فقرا في هذا الجانب، وهناك فرق بين الدراسات الاجتماعية والتاريخ الاجتماعي، ولعل بعض كتابات الدكتور علي الوردي كانت من الدراسات القليلة التي انتشرت بين القراء، كما أن الدكتور محمد أنيس من طلائع من اهتموا بهذا الجانب وصدر له عدة كتب منها: تطور المجتمع المصري من الإقطاع إلى ثورة 23 يوليو. واطلعت أخيرا على كتاب كبير للدكتور خالد أبو الليل اسمه: التاريخ الشعبي لمصر في فترة الحكم الناصري. لكن الأمر كذلك اختلف مع ظهور الصحافة ثم الإذاعة وما تلا ذلك من وسائل الاتصال الاجتماعي، فالصحافة سدت منذ نشأتها فجوة كبيرة، وكانت تسير باطراد نحو تأريخ المجتمع من خلال المقالة الناقدة له والأخبار الاجتماعية التي تطرحها، والحوادث التي تنقلها ويصنعها الناس، ما يمكن من رصد نشوء وتطور بعض الظواهر والتكتلات الاجتماعية، ولهذا فإن الباحث في التأريخ الاجتماعي سيجد في الصحافة ثم ما تالها من الوسائل الحديثة بغيته. كما كان للمذكرات الشخصية والسير الذاتية دور في رصد هذا التاريخ الاجتماعي، من خلال حديث السارد عن تفاصيل حياته المكتظة بالمواقف الاجتماعية، لكنها من وجهة نظره.
أن تتحول الغيبة إلى نوع من النبل في كتابة التاريخ فذلك أمر يدعو إلى الدهشة، فالجاحظ يقول: إن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود كان من نبلاء المغتابين.
عندما قال الجاحظ هذه العبارة كان يفسر سلوك عبيدالله، الذي قال في شعر له:
فإن أنا لم آمر ولم أنه عنكما... ضحكت له حتى يلج ويستشري
ولا يقصد الجاحظ الغيبة بعينها وإنما من شارك في التحريض عليها، فكان فعل عبيدالله محرضا من خلال تلك الضحكات التي يشجع عليها، والضحك ليس كالما ينقل وينتشر وإن كان يستدل به على توجه الشخص فقد كان ذلك الضحك من عبيدالله مشجعا على الوقيعة ومن ثم لم يمارسها صراحة، ولهذا عد من نبلاء المغتابين بفعله التحريضي وليس بفعله القولي، حين تصاون عن الوقيعة من خلال تحريضه عليها وليس بمباشرتها.
هناك فارق شاس ع بين الكلام والظن والاختيار، فهل الأمر مختلط في عصرنا الحاضر بعكس ما كان يفهمه العرب في عصور سابقة؟
الأمر مرتبط بقدرات العقل عند الإنسان، من ناحية المهارة الكلامية والمخزون المعرفي والمطابقة العقلية والنفسية، وأيها تكون له الغلبة، والتأثير الأكبر على تصرفات الفرد، كما أنه مرتبط كذلك بالنشأة والتربية، والانعكاسات النفسية على الفرد من خلالهما. وفي عصرنا الحاضر نجد التقسيم الذي ذكره الجاحظ: شعر الرجل قطعة من كلامه، وظنه قطعة من علمه، واختياره قطعة من عقله. ال نزال نردده، ونجد صداها في حياتنا، فالشخص البارع في الحديث لا يكون عند الناس موصوفا بحسن الظن والاختيار، وعلى العكس قد يكون الذي ال يملك الفصاحة حسن الاختيار صادق الظن. وقد تجد شخصين شديدي العالقة متنافري المعارف والطباع ومرد ذلك إلى الاختيار، الذي جعلهما مطابقان لبعض من ناحية تشكل مفصال في علاقتهما، كالاتفاق على الشح والبخل أو كره العامة كما في عالقة ( الطرماح والكميت).
لماذا يعد (الجاحظ) عالمة فارقة في التاريخ العربي؟
الجاحظ عالمة فارقة في تاريخ الأدب العربي، ذلك أن لفكره الذي نثره في كتبه أثر على جميع المذاهب والاتجاهات في الحضارة العربية، وكانت له رؤية حرة تنطلق من عقل مفكر يمتطي التجريب والملاحظة في كثير مما يقرره، وقل أن يستغني الدارس والباحث والقارئ عن كتبه، لقد كانت كتابات الجاحظ تلامس قضايا المجتمع، في البخلاء وفخر السودان على البيضان وذم الكتاب والقيان، إضافة إلى كتبه كالحيوان والبيان والتبيين متخذا منهج التجريب والتعليل والبحث والتقصي وتقليب الأمر، ما ولد فرادة جعلته من أهم مفكري الحضارة العربية، حتى أن أبا حيان التوحيدي يقول: إن مذهب الجاحظ مَدَّبٌر بأشياء لا تلتقي عند كل إنسان، ولا تجتمُع في صدر كل أحد: بالطبع والمنشأ والعلم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ، وهذه مفاتح قل ما يملك ها واحد، وسواها مغالق قل ما ينفك منها واحد. ولهذا فال يستغني عن كتابات الجاحظ السواد الأعظم من مفكري العربية، يقول المستشرق الفرنسي الجاحظي (شارل بيلا): على جميع الباحثين أن يعولوا عليه، ويرجعوا إليه عندما يشرعون في دراسة موضوع من الموضوعات، مهما كان جنسه وشكله، حتى قلت مرة إني لو دعيت إلى القول في تربية النحل، أو تحديد النسل، لما استغنيت عن الاعتماد عليه، والإشادة بذكره. ومع الأسف فإن الدراسات التي خرجت عن فكر الجاحظ قليلة وبعضها أكاديمي حبيس الأدراج.
ما الآراء التي تعارض الجاحظ؟
يمثل الجاحظ مدرسة مستقلة منبثقة عن المعتزلة، لكن رسالته العقدية لم تكن ذات حضور يذكر فعد ناقدا أدبيا ومفكرا تجريبيا، ولعل ضياع بعض كتبه الكلامية لا تمكننا من سبر غور فكره العقدي والاعتقادي، الذي كان له أثر على من جاء بعده كعبد القاهر الجرجاني وأبي حيان التوحيدي وغيرهما، لكن الجاحظ بصورة جلية كان معارضا من قبل المحدثين الذين يرونه متكلم المعتزلة فيما يرون معاصروه المتأخرين قليلا ابن قتيبة متكلم أهل السنة، وبمعرفة هذين العلمين وتضادهما عند أهل السنة نعرف معارضي الجاحظ.
أجريت دراسة عن كتاب الأعلام للزركلي، فما هي أبرز ملاحظاتك؟
يعد كتاب الأعلام من مفاخر المؤلفين المحدثين، كان مشروع عمر لمؤلفه، لم يدخر في خدمته بماله وجهده، ومن تابع طبعاته رصد ذلك التطور الكبير الذي لحق الكتاب، مزاوجا بين طرائق المتقدمين وتقنيات العصر، من الصور والمصورات، لكنه كأي عمل بشري لا يمكن أن يصل للكمال، فقد شابه بعض القصور، الذي ال يقدح فيه. لكنه يبقى حسنة من حسنات المعاصرين من العرب يفاخرون به المتقدمين. وهذا الكتاب (تعاورته) في طبعته الأخيرة التي صدرت بعد وفاة مؤلفه سنة 1396هـ أيد عابثة حذفت وأضافت وهو مما يجب الابتعاد عنه، ولهذا فإن أي تعديل أو تصحيح للكتاب يجب أن يكون خارجيا أي في مؤلف أو مقال دون المساس بمتن الكتاب.
ألم نعد بحاجة إلى تأليف كتب عن الأعلام؟
لا نزال في حاجة لتراجم الأعلام، وإن كان ذلك غير ملح كما في العصور السابقة، ذلك أن مصادر الشبكة العنكبوتية والصحافة قد تفقد بعضها المصداقية أو الإنصاف، كما أن السير المكتوبة لكثير من الأعلام تحمل صورة واحدة عن المترجم، ألن كثيرا منها مدفوع الأجر، أو تحمل حيفا عن هذا المترجم له.
لماذا كثرت كتب الأعلام في القرون الماضية؟
غلبة التاريخ الفردي في الحضارة العربية أنتج كثيرا من الكتب في التراجم، التي يرتبط بعضها بسوق بعض، متبعة نظام التذييل الذي نجده في بعضها بالاسم وبعضها الآخر بالفترة التاريخية المستهدفة. وهذه الكتب تختلف من حيث القيمة، فبعضها بلغ الغاية وبعضها ضعيف اتكأ على غيره فنقل وبوب فقط. ولعل من أسباب كثرتها: كثرة الأعلام البارزين في جميع المجالات في الحضارة العربية، مع أن هذه الكتب قد أخلت بتراجم علماء العلوم الطبيعية، إلا أنها كانت ثرية وغنية بتراجم كثيرة للأعلام فبقدر ما تزدهر الحضارة يكثر الأعلام الذين يستحقون الترجمة لهم. كما أن لعلم الجرح والتعديل أثر في كثرة التأليف في علم التراجم وما يخدمه كالرسم والنسب والمتشابه وغير ذلك، ومن ثم زاوج المتأخرين من علماء الجرح والتعديل بين مؤلفات الجرح والتعديل ومؤلفات التراجم، وخير مثال عليها موسوعتي الذهبي: تاريخ الإسلام وسير أعالم النبلاء.
كلمة منديل قد يظن البعض أنها كلمة حديثة لكن خلال بحثك عثرت عليها في الشعر الجاهلي، فمن أول من استخدمها؟
نعم وردت في شعر جاهلي قاله عبده بن الطبيب:
وثمت قمنا إلى جرد مسو ٍمة...... أعرافُهَّن أليدينا مناديل
ويظن البعض أن العرب كانوا أمة قبل اختلاطهم بالأمم لا يعرفون شيئا من أدوات الحضارة لكن العرب كانوا يعرفون كثيرا من الأدوات المدنية ومنها المناديل التي كانوا يستخدمونها وكثيرا ما شبهوا أعراف خيولهم بالمناديل. أما أول من استخدمها لغويا فهو سؤال عويص حيث أن استخدامها قديم بقدم اللغة العربية، لأن منديل اسم عربي وليس معربا.
وما أنواع المناديل؟
يحتاج هذا إلى استقصاء ولعل من أشهرها: مناديل اللين، وكانت تتخذ في اجتماع الندماء على الشراب .مناديل الحمام، وهي ما نسميه اليوم بالفوطة وهي معربة. منديل الخوان، يكون مع الطعام. مناديل المتاع يحمل فيها المتاع كالبقشة. ومن أعجبها مناديل الغمر، وهي مناديل لا تغسل وإنما تلقى إذا اتسخت فى النار فيزول ما علق بها ولم يحترق منها شىء، تصنع في الصين، تؤخذ من ريش طائر يسمى السمندل. ومنها منديل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أكل طعاما مسح يده على قدمه، وقال: هذا منديل عمر وآل عمر. وكان الحسين رضي الله عنه يسمي المساكين مناديل الخطأ، فبهم تمسح الآلام والمصائب، وعليهم تقع المحن والكوارث.
كل الحقوق محفوظة لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة © 1446-2025